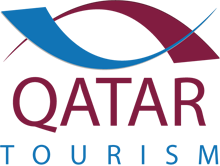ملجأ العامرية ببغداد.. ما لا تمحوه السنوات
ليث ناطق-بغداد
لم يختر خالد اتجاها يهرول إليه، فقد كان شعلة نار تركض فترتطم بالجدران حتى وصل إلى باحة بيت علي الذي سقط بابه الخارجي متأثرا بقوة الانفجار لينقذ عليا وعائلته وما تبقى من جلده المشتعل بأغطية النوم.
بعد 28 عاما على الحادث وأمام ملجأ العامرية يقف علي (43 عاما) شابكا كفيه خلف ظهره، يوزع نظراته في جوانب الملجأ وكأنه يحدق في صحراء ممتدة.
استغرق كثيرا وهو يبحث عن كلمات “أخذه انفجار آخر” هذا ما جاد به صمته، نجا خالد -الذي صار طبيبا فيما بعد- من موت محتوم في مأساة ملجأ العامرية، لكنه لم ينج من انفجار مزدوج وقع قرب عيادته سنة 2010 ليلتحق متأخرا بباقي أفراد أسرته الذين قضوا في الملجأ.
لم ينجُ من الملجأ سوى تسعة أشخاص، فقد تحول بفعل صاروخين ذكيين لطائرة أميركية إلى فرن تفحم داخله أكثر من أربعمئة شخص، كان ذلك في ليلة شتائية ملتهبة يوم 13 فبراير/شباط 1991.
أصاب الصاروخ الأول المصنوع خصيصا لاختراق الجدران الإسمنتية سقف الملجأ فتسبب بإغلاق بواباته الفولاذية، ثم تبعه صاروخ ثان حول الملجأ إلى فرن صهر أجساد العائلات التي كانت تحتمي داخله.
على بعد زقاقين من الملجأ تنبسط ذكرى نهر أبو غريب تحت بيوت من الصفيح، النهر الصغير الذي وهب حياته لإسعاف ضحايا الحادثة الأليمة، حيث استخدم رجال الإطفاء ماءه لأسبوع بعد الحادثة، في محاولات لإخماد ألسنة النار التي كانت تلتهب كلما انطفأت.
| الملجأ يحافظ إلى الآن على ندوب القصف الذي تعرض له عام 1991 (الجزيرة نت) |
ذكرى مريرة
يستذكر محمد (38 عاما) -الذي يسكن بجانب الملجأ- هذا الجزء المؤلم من طفولته، واصفا إياه بالمرعب، حيث يقول في حديثه للجزيرة نت “كنت صغيرا لكنني ما زلت أذكر أصوات الصراخ التي تلت الغارة في تلك الليلة المشؤومة، ما زالت الأصوات توقظني من منامي”.
توسل الطفل الذي كان والده يذهب بهم إلى الملجأ، كان انقطاع التيار الكهربائي في البيوت يدفعه وإخوته الصغار إلى ذلك، واجتماع أصدقائه وعائلاتهم في الملجأ يغريه، لكن أباه اختار البقاء في البيت تلك الليلة وكأن القدر اختار أن يكونوا شاهدين على تفحم جيرانهم.
“أتذكر جيدا العمة أحلام جارتنا حين أخرجوا جثث الضحايا، كيف احتضنت أطفالها وزوجها، كانت تحتضن كتلة لحم سوداء يتصاعد منها الدخان” يقول محمد.
وبحكم قرب منزله من النهر كان محمد يقضي أيام ما بعد الغارة وراء نافذة حجرته التي تناثر زجاجها عليهم في تلك الليلة وهم نيام، يعد سيارات الإطفاء التي كانت تسحب مياه النهر فيخطئ ويعيد الكرة فيخطئ، فصار يعد السمك النافق في النهر الصغير بعد أن نفد ماؤه، وما زال تائها على الرغم من أعوامه الـ38 والشيب الذي كسا لحيته.
قرب جامع ملوكي في منطقة العامرية ببغداد يقع منزل أم رغداء، السيدة التي اختارت هي وزوجها أن يهجرا بيتهما ويعيشا في الملجأ “كانت تحرس الملجأ أو تحرس روح ابنتها العروس رغداء”.
تقول جارتها الحاجة أم صلاح سكن والدا رغداء كرفانا في الملجأ بعد الحادثة بفترة حتى الغزو الأميركي للعراق 2003، حينها اختفيا ولم يعرف أحد شيئا عنهما.
| ملجأ العامرية تحول مؤخرا إلى مقر للمجلس البلدي (الجزيرة نت) |
رغداء العروس
“كانت رغداء تتجهز لزفافها، اشترينا فستان الزفاف أنا وأمها، على أمل أن تنقضي الغارات وتتزوج” تقول أم صلاح.
لم تعرف الشابة رغداء أن الغارة الآثمة ستطير بروحها إلى السماء، وربما كانت أمها حريصة على وصولها آمنة إلى هناك كحرصها على اختيار فستان أنيق لابنتها.
واظبت أم رغداء على إشعال الشموع في الملجأ على مدار سنواتها التي قضتها حارسة هناك، كانت تستقبل عوائل المفقودين وأصدقاءهم، وتشاركهم حزنهم باستذكار من فقدوا.
ما زال الثقب الذي صنعه الصاروخان مفتوحا في سقف الملجأ وفي قلوب ذوي الضحايا ومحبيهم، وما زال نصب العلم العراقي يلف القبور الرمزية في باحة الملجأ، لكن الجدار الذي كان يحمل صور الضحايا تخلى عنها، ويبدو أن السلطات تخلت عن عنهم أيضا، فبعد 2003 مرت بناية الملجأ بمراحل عدة لم تكن إحداها أنه صار ذكرى أو ملجأ لأرواح ضحاياه، فصار تارة مقرا لأحد الأحزاب، وتارة أخرى ثكنة عسكرية للجيش، واليوم هو مقر للمجلس البلدي لمنطقة العامرية.
تقول سناء (44 عاما) بأسى وقد فقدت عائلتها في الملجأ ولم يبق سواها وأختها “أتمنى لو أنهم أخلوه وسمحوا لنا بإقامة تأبين سنوي، فأرواحهم تستحق ذلك”.
المصدر : الجزيرة