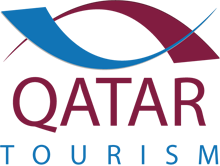معرض للكتاب أم للروايات.. لماذا يترك الشباب المعرفة ويذهب للخيال؟
“الحب اللى بجد هو اللي الدنيا عمالة تهيئك ليه من ساعة ما اتولدت، بكل حاجة وحشة وكل حاجة حلوة، بعلاقات بايظة وجراح ماتتنسيش، الحب بيبدأ بجد لما القلب يسأل سؤال صغير كده قوي بيفرق في كل حاجة، لما بيسأل هو أنا مش هرتاح بقى، الحب أصله استعداد نفسي، عشان كدة مرحلة البداية أهم مرحلة بكل اللخبطة اللى فيها لأنها هي اللي بيجي فيها لحظة معينة بنقدر نستسلم لأننا ممكن نتوجع تاني”
(محمد صادق، هيبتا)
في الخامس من فبراير/شباط الحالي، أغلق معرض القاهرة الدولي للكتاب -في دورته الخمسين- أبوابه أمام الجمهور، الذي استمر في التوافد على مدار أسبوعين هما فترة المعرض، لتنتهي أرقام المبيعات كما جرت العادة في الأعوام السابقة، بتصدر واضح للرواية عن غيرها من فنون التأليف[1]، ولم يقتصر الأمر على مصر وحدها، بل امتد للعراق كذلك، وكثير من الجغرافيا العربية، الأمر الذي يأتي كترجمة منطقية للفارق الكبير في التأليف والنشر الروائي مقارنة بنظيره البحثي والعلمي، خاصة في الدور الشبابية الجديدة التي تستند على الروايات في المقام الأول.
وفي نمط متكرر من الأدب المتواضع، والذي لا يرقى أحيانًا لمسمى الأدب، كانت بعض الروايات تتكرر برتابة متجددة مع كل عام جديد بكتابات لا يبدو فيها الإحكام البياني ولا العمق الفكري أو الإبداع الأدبي. تلك الظاهرة؛ أضحت متسيدةً في الأعوام الأخيرة، خاصةً تلك التي أعقبت الربيع العربي، والتي لا يبدو أنها محض مصادفة والسلام، إذ أن الزخم الشبابي داخل المجال العام، بما استتبعه ذلك من اعتداد الشباب بنفسه ورغبته في التعبير، أسفر عن هذا الحراك التأليفي لديهم.
لكن على ما في ذلك من إيجابية، فإن الكاتب “أسامة الهتيمي” يرى أن هذه السعادة بالمشاركة الشبابية كان اكتمالها ممكنًا “لو أن صدور هذا الكم من الروايات الأدبية كان جزءًا من حراك ثقافي شامل يعبر عن نهضة ثقافية وفكرية يكون الأدب بعمومه (رواية وشعرًا وقصة.. إلخ) أحد أعمدتها”[2].
غير أن هذا الطوفان الروائي، كما يضيف “الهتيمي”، قد جاء، وبكل أسف، كتغريد خارج السرب، ليكشف عن أزمات في واقعنا الثقافي والفكري أكثر مما يعبر عن حالة ازدهار ثقافي ما تزال مفقودة. وهو ما تعلق عليه “سعاد العنزي” بفوضى التأليف الروائي، إذ أنتج هذا الزخم كمًا خادعًا من المؤلفات لا يعبّر بالفعل عن تطور الحالة الثقافية في المجتمع، مما يعطي رقمًا إيجابيًا دالًا على نتيجة صفرية لدى الكثير من المؤلفين الشباب.
تضيف سعاد أنه ونتاجًا لهذه الفوضى، “قد بدأ القارئ العادي والمثقف يتساءلان عن أحقية انتماء بعض النصوص للجنس الروائي بعد أن أخلت هذه الكتابات بمفهوم الرواية، المتعارف عليه في ذهن القارئ”[3]. كما تُرجِع تلك النتيجة السلبية إلى استسهال النشر والتأليف اللذين جعلا بعض المفاهيم الروائية غائبة عن الكثير، حتى أن أحد هؤلاء المؤلفين الشباب، من مشاهير مواقع التواصل، علّق على النقد اللاذع الذي تلقّاه بأنه لن يستطيع التوقف عن الكتابة ولكنه لن يمانع في حضور ورشة للكتابة لتحسين مستواه[4].
تلك الحالة تتكرر مع عدد غير قليل من المؤلفين الذين لا يعرفون عن ذلك الفن شيئًا، فهذا الكاتب المذكور وإن كان أصدر كتابًا للخواطر الشعرية، إلا إنه لا يختلف عن كثير ممن كتبوا الرواية بالعامية المصرية، وبسطحية درامية ركيكة، الأمر الذي يدفعنا للتساؤل حول الدوافع التي قادتهم إلى هذا الصنف من التأليف دون غيره؛ ليمنحونا هذا الكمّ الهائل من التكرار والإغراق الروائي للوسط الثقافي. فأين يكمن الخلل؟ ولماذا يهرب الشباب إلى الرواية بهذا القدر؟
“الرواية هي ملكة الأجناس الأدبية”
(تيري إيجلتون)
في كتابه “فن الرواية، حاول الأديب العالمي “ميلان كونديرا” سبر السؤال الذي شغله طيلة مسيرته الأدبية: ما الرواية؟ ماذا تحمله لنا؟ وفيمَ هي ضرورية؟ فيقول أن “مجموع أعمال كل روائي ينطوي على رؤية ضمنية عن تاريخ الرواية وعن ماهيتها”. غير أن “باختين” لا يرى أن ثمة تعريفًا صلبًا يمكن إحكامه حول الرواية بسبب تطورها الدائم، فهي نوع يعيد النظر في كل الأشكال التي استقر بها، كما يرى[4].
وتضيف “العنزي” أنه، مهما اختلف الأدباء حول تعريف الرواية، فإن التمكن من تقنيات السرد والخطاب الروائي هو ما يمكنه تصنيف الكتابة باعتبارها إبداعية من عدمها، مثل اللغة الأدبية، والحبكة المتماسكة، والبنية الزمانية والمكانية، والصوت السردي الذي قدمت به الرواية: سواء بضمير الغائب، أو المتكلم أو المخاطب… فمن دون إتقان وإحكام لهذه العناصر الروائية لا نستطيع اعتبار العمل المقروء روايةً بأي حال.
وبسحب هذا إلى التفشي الروائي الأخير فإن “الهتيمي” يرى أن عددًا من هؤلاء الروائيين الشباب لا تتجاوز رواياتهم حد “الحواديت الفارغة التي لا تمت للأدب بشيئ، لا على مستوى الصياغة واللغة ولا على مستوى المضمون والفكرة”، إذ أن إقبال هؤلاء على الإنتاج الروائي إنما جاء “نتيجة استشعارهم -بمنظور سطحي يخلو من الرؤية النقدية لمرامي الروائي الحقيقي- أنهم امتلكوا التكنيك الفني للكتابة”[2].
ازدهار الرواية أحيانًأ يكون ازدهارًا بائسًا؛ لأن المسألة ليست في الكم وإنما في قدرة الرواية على التعبير عن مأزق ولحظة موحلة نعيشها
تلك النتيجة التي أدت بهم، كما يضيف، إلى الكتابة المتغافلة عن كثير من الاعتبارات التأسيسية للرواية “مثل الرمزية، والإسقاطات، والتأملات الفلسفية، وضخ المضامين الفكرية والأبعاد الأيدولوجية، والفهم الشامل لأبعاد شخصيات الرواية التي يحرص كل أديب ناضج على توصيلها إلى القراء” وهو الأمر الذي أنتج غيابه روايات “ينتهي أثرها بانتهاء قراءتها” إذ نسي هؤلاء أن “كاتب الرواية لا بد وأن تكون لديه تراكمات ثقافية وفكرية وتاريخية وفنية لتتجاوز رواياته حواديت جدي وجدتي”.
في ذات السياق، تعلّق الروائية “سلوى بكر” أن “ازدهار الرواية أحيانًأ يكون ازدهارًا بائسًا؛ لأن المسألة ليست في الكم وإنما في قدرة الرواية على التعبير عن مأزق ولحظة موحلة نعيشها”[5]، وعلى الرغم من اعتبارها هذا الازدحام الروائي ظاهرةً إيجابية، كونها ستخرج حتمًأ روائيين موهوبين، إلا أن ذلك لن يحدث دون حركة نقدية تعمل وفق معايير وأسس واضحة، وهو ما يتضاءل كثيرًا أمام الاجتياح التجاري الذي يُسلّع الرواية ويفرّغ الأمر من معانيه، وهو ما يدفعنا كذلك للاستفهام حول هذا الجنوح المبالغ فيه صوب الرواية دون غيرها.
“لا بد من كاتب رديء باستمرار، وذلك لأنه يُشبِع ذوق الأجيال الشابّة التي لم تتطوَّر بعد”
(نيتشه)
لماذا نكتب؟ ولمن؟ ليس السؤالان جديدَين، كما يرى الكاتب الصحفي “محمد المحفلي”، بل “إنهما قديمان ومتجدّدان بتجدّد الكتابة نفسها” حتى أن “كتبًا أُلّفت في محاولة للبحث عن إجابة لهما، سواءً بمؤلفات خُصّصت لهما، أو بشكل غير مباشر من خلال تضمينهما في تلك الكتابات”[6]، ويرى الكاتب “لؤي طه” أن كل فكر لا ينتج أثرًأ ملموسًا هو محض فراغ وعدم “وفقاعة صابون ما تلبث أن تتبعثر في الفضاء وكأنها لم تحدث أصلًأ”[7].
وبالعودة إلى الهجوم الكاسح على الرواية، فإننا سنجد عشرات، وربما مئات، من الروايات التي تصدر سنويًا دون دوي يبقى لأكثر من فترة المعرض، المصحوبة بحفلات التوقيع العامرة بأصدقاء الكاتب أو جماهيره على مواقع التواصل، وهو ما يرجعه البعض لأسباب ربحية تتعلق بالجوائز المقدمة لأفضل الأعمال الروائية أو بالعائد الذي تحققه دور النشر.
وعلى ذكر ذلك، يقول أحد مديري دور النشر بالقاهرة أن “الدار تشجع الشباب في أول أعمالهم وتعطيهم الألولوية والفرصة؛ حتى لو لم تكن كتاباتهم تروق للوسط الثقافي والنقاد، المهم أن تكون لدى الكاتب موهبة وحاسة”[4]، الأمر الذي يبدو غريبًا، مع افتراض حسن النية الكامل، إذ أن عملًا يخرج للجمهور من أنصاف المؤهلين بحجّة تشجيعهم، هو عذر أكثر غرابةً من الفعل نفسه.
ترى الدكتورة “فاطمة البودي”، رئيس مجلس إدارة دار العين للنشر في القاهرة، أن المسابقات والجوائز لعبت “دورًا كبيرًا في جعل بعض الكُتّاب يستعجل في كتاباته، ولا يستعد الاستعداد اللازم لتأليف رواية تستحق التقدير، ومن جانب آخر سارع بعض الناشرين غير المهتمين من قبل بنشر الروايات لإنتاج هذا النوع من الأدب دون الاهتمام بوجود من يراجعها، ودون الاهتمام بالجوانب المختلفة في النص”[5].
وعلى الرغم من ذلك، فإن الناقد العراقي، وأحد أعضاء لجنة تحكيم جائزة البوكر 2015، “نجم عبد الله كاظم” يخبرنا أن اللجنة صُدِمت من العدد الكبير للأعمال الهابطة التي لا ترقى للترشيح، بل لا ترقى للنشر من الأصل، فيقول: “كنت أقول لبعض رفاقي في اللجنة، كأستاذ جامعي، لو كنت أمارس التعليم ومررت على هذه الروايات سأعاقب المؤلفين والناشرين”[5].
الأجواء السياسية انعكست بالسلب على الجانب الثقافي والفكري، مما نحا بالشباب إلى الهرب من واقعهم من خلال الرواية السطحية
وهو ما تناوله المحرر “إبراهيم هلال” من قبل تحت عنوان “فيالق الحمقى”، فيقول أن “المتابع لهذا النوع من الأدب سيرى، خاصة في الفترة الأخيرة في مصر، ظهور روايات باللغة العامية تعتمد بشكل أساسي على تفاعلات الأحاديث اليومية، والتي أظهرتها بشكل كبير مواقع التواصل الاجتماعي التي حولت الأحاديث اليومية لأشكال أخرى أكثر مشهدية، حيث تعتمد بشكل أساسي وتنافسي على الكتابة والصورة”[8].
“إن موت الرواية ليس فكرة وهمية، لقد سبق له أن تحقق، ونحن نعرف حاليًأ كيف تُحتضَر الرواية؛ فهي لا تختفي بل إن تاريخها يتوقف”
(ميلان كونديرا)
يبدو التكرار احتضارًا كما رأى “كونديرا” إذن، ولكن هل يكون التكرار نصل القتل الوحيد؟ ماذا عن الاستعمال الخاطئ لتقنيات الفن؟ أن تمتلك قطعة ثمينة من الماس ثم تستهلكها في تزيين الجدار. من تهمه زينة الجدار في منزل لا يدخله الطعام؟ ما أسخف الإمكانات المهدرة!
ثم، هل قابلت الرمزية ذات يوم في إحدى الروايات؟ تلك هي أداة الفلسفة في خضم الأدب وآلة الاحتجاج والرفض في صور المجاز، هذا هو الهروب الصغير الذي لا ينفصل عن الواقع بالخيال المحض، وإنما يطوّع الأخير للتعبير عن الأول، ولكن ما يحدث مع الكثير من الشباب قد بدا أنه الهروب الكبير.
يرى “الهتيمي” أن الأجواء السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية قد انعكست بالسلب على الجانب الثقافي والفكري، “فباتت عملية التأليف في المجالات غير الأدبية من ناحية رهنًا لاعتبارات تتعلق بتوجهات المؤسسات والهيئات القائمة على تمويل إصدار المؤلفات الجديدة ومن ناحية أخرى أصابت الكثير من الكتاب والمؤلفين بحالة من الفزع خشية الوقوع في براثن حالة الاستقطاب السياسي الحادة التي سادت المجتمعات العربية”[2].
الأعمال لم يعد يشترط فيها الجودة وإنما الشهرة، حتى ولو كان المنتَج لا يرقى إلى مستوى “قعدات المصاطب” التي كانت، بالمناسبة، راقيةً
الأمر الذي نحا بالشباب إلى الهرب من واقعهم من خلال الرواية السطحية، ضحلة الأبعاد والشخصيات، متعامين عن أدواتها من المجاز والرمز التي تصلح للهرب من الباب الخلفي، ولكنها لا تهجر عمق الحياة إلى السطح بهذه الصورة المختزلة التي تصور الدنيا كلها في صورة حبيبين يفترقان، أو يلتقيان، وهو الأمر الذي يعلّق عليه مجموعة من المؤلفين الشباب، أنفسهم، ممن خاضوا تجربة التأليف وساءهم ما وجدوه في أوساطهم من ضيق الأفق الأدبي؛ حتى أن منهم من اعتزل الأدب مؤقتًا حتى تتشكل لديه الصورة بشكل أفضل.
فيقول الكاتب الشاب “الحسن البخاري” لميدان: أن واحدًا من الأسباب الكبرى التي تسببت في هذا التناول السطحي للرواية في معزل عن الواقع، إنما يرجع للجهل الشديد من قِبَل هؤلاء الكتاب بطبيعة الرواية وأدواتها، فهم لا يعرفون تاريخها ولا مراحل تطورها، فضلًا عن أن يستوعبوا قوتها كصيغة فنية للاشتباك مع الواقع والترميز له وانتقاده بصورة فنية تختلف عن العمل الصحفي أو العلمي.
ويعلّق “يوسف الدموكي”، وهو كاتب شاب أصدر أطروحته الأولى في العام الحالي، لميدان أيضًا، قائلًأ أن عددًا من الكُتّاب الشباب “لم يعرفوا معنى أن تكتب رواية ولم يدركوا مدى تأثيرها وأهميتها في صنع الوعي وحشد القلب وإيصال الرسائل، كما يُرى في روايات غيرت مجرى التاريخ مثل كوخ العم توم أو وضحت ما يجري به مثل روايات جورج أورويل أو حكت جزءًا منه كما فعلت رضوى عاشور أو عايشته كما فعل أحمد خالد توفيق”.
فصارت الرواية، كما يضيف، “هي النوع الأسهل والأقرب لِأن يجد أحدهم حوضًا يتقيأ فيه، ومن الحوض إلى ماسورة طويلة ممتلئة بعيون القراء ضحايا الأعمال المبتذلة، لأن هبوط المجتمع كليًا يهبط بذوقِه كذلك، والجريمة الكبرى هي تلك التي ترتكب من قبَل دور النشر، لأن الأعمال لم يعد يشترط فيها الجودة وإنما الشهرة، حتى ولو كان المنتَج لا يرقى إلى مستوى “قعدات المصاطب” التي كانت، بالمناسبة، راقيةً، يديرها أجدادُنا ويحكون بها أخبار البلد في حبكةٍ ارتجالية لا ترد لروائيي هذا الزمن”.
في النهاية، فإن ظاهرة كتلك لا تبدو أن ستجود بما ورائها دفعةً واحدة، فمع كل عام نكتشف شيئًا عنها وأشياء منها، فنعرف إلى أي مدى صار الاستسهال قاتلًا للأشياء الجميلة، ونبصر من خلف هذا آليات الدفاع ضد الإحباط، إذ بدا عددًا من الشباب وكأنهم غارقون في التيه، فهم قد أدركوا كِبَر واقعهم بعد الربيع العربي، فأرادوا الانخراط فيه ولكن بأدوات ناقصة، في الوقت الذي سُحِب فيه بساط الحريات، فتاه هذا الجمع في حكاوي العشاق المستهلكة عن دنياهم المتجددة، ولم يستفيدوا من الرواية كمساحة للتعبير، ولم يفيدوها هم بإتقان ومعرفة على وجه سليم، فأصبحوا وهي كسراج أُوقِد ضياؤه، ولكنه لم ينير الطريق.